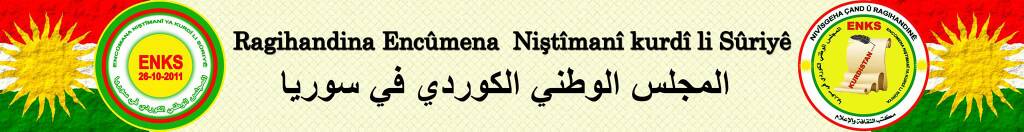ثقافة تقبّل الآخر…
ضرورة وجودية لبناء الإنسان والمجتمع

بقلم الكاتب بنكين محمد
في عالمٍ تتسارع فيه التحولات، وتتشابك فيه الصراعات، وتتصاعد فيه الأصوات المتنافرة، يبدو أن أخطر أزمة يواجهها الإنسان المعاصر ليست أزمة اقتصاد أو سياسة فقط، بل أزمة ثقافة؛ ثقافة ما تزال عاجزة عن استيعاب حقيقة بسيطة: أن الإنسان مختلف بطبيعته، وأن هذا الاختلاف ليس لعنةً أو تهديداً، بل قيمة إنسانية عميقة تُغني الحياة وتمنحها ملامحها المتعددة.
لقد صار مفهوم تقبّل الآخر اليوم محوراً مركزياً في النقاشات الفكرية والاجتماعية والسياسية. ليس بوصفه شعاراً يرفع في المؤتمرات، بل كفلسفة حياة، وكقاعدة تأسيسية لأي مجتمع يسعى لأن يكون مستقراً، سليماً، قابلاً للنمو، وقادراً على إنتاج حضارة
تقبّل الآخر ليس مجرد تحمّل وجود المختلف عنك، بل هو إدراكٌ واعٍ بأن هذا الاختلاف جزء من طبيعة الكون.
هو القدرة على رؤية الآخر كما هو، بهويته وملامحه وخياراته وانتمائه، دون محاولة إعادة تشكيله ليتوافق مع رغباتنا أو مرآتنا الداخلية.
تقبّل الآخر يعني أن تتشارك الحياة مع من يختلف معك في:
اللغة، الدين، القومية، الرأي السياسي، نمط التفكير، أسلوب الحياة.
أن تتعايش معه بلا خوف، بلا تحامل، وبلا نزعة للهيمنة.
رغم بساطة المفهوم، إلا أن التطبيق في الشرق الأوسط، والسوري خصوصاً، يواجه تحديات عميقة. ذلك لأننا تربينا ضمن منظومات مغلقة:
- العائلة التي تعلّم الطفل منذ صغره أن من يشبهنا أفضل وأن المختلف مصدر تهديد.
- المدرسة التي تبني ذهنية التلقين، حيث يختفي الحوار ويُختزل الفكر في إجابة واحدة صحيحة.
- الأنظمة السياسية التي طالما غذّت الانقسام، وزرعت الخوف من الآخر، لتضمن بقاءها على حساب تنوع المجتمع.
- الإعلام التقليدي الذي لم يتردد في تضخيم الفُرقَة والتحريض وإنتاج صور نمطية، ساهمت في صناعة عقلية الإقصاء.
هذه العوامل صنعت إنساناً يعيش داخل “فقاعة” فكرية صغيرة، يخشى الخروج منها، ويعتقد أن المختلف تهديد وجودي.
الإنسان الذي يتقبّل الآخر هو إنسان ناضج.
لا يحتاج أن يرى العالم بعيّن واحدة، ولا يخاف من تعدد الأصوات.
هو من يدرك أن التنوّع لا يُضعف الهوية، بل يثريها.
الفيلسوف الفرنسي فولتير قال يوماً: قد أختلف معك، لكني مستعد أن أدفع حياتي ثمناً لحقك في أن تقول رأيك.
هذه ليست جملة شعرية، بل حجر الأساس في بناء مجتمع يحترم الحوار.
أما المجتمعات التي ترى في الاختلاف تهديداً، فهي تترك الباب مفتوحاً أمام:
التطرف، العنف، الإقصاء،
والثقافات الأحادية التي تُلغِي الآخر، ومن ثم تلغي ذاتها.
هذه الثقافة لا تأتي بالتمنّي ولا بالشعارات. إنها مشروع يبدأ من الفرد ويكبر شيئاً فشيئاً.
- التربية المنزلية
حين تعلّم الأم طفلها أن المختلف ليس عدواً، وأن كل البشر متساوون، فهي تبني مجتمعاً صحياً دون أن تدري.
- المدرسة الحديثة
المدرسة التي تتيح مساحة للحوار، وتشجع التفكير النقدي، وتتعامل مع التنوّع كجزء طبيعي من العملية التعليمية، تُخرّج مواطنين لا يخافون من الآخر.
- الإعلام ومسؤوليته
الإعلام الذي يحترم العقل، ويبتعد عن الكراهية، ويُبرز النماذج الناجحة في التعايش، يلعب دوراً جوهرياً في ترسيخ ثقافة تقبّل الآخر.
- القوانين العادلة
القانون هو الضامن الأخير لسلامة المجتمع.
قانون يحمي الأقليات، ويجرّم خطاب الكراهية، ويعزز المساواة، هو حجر الأساس لأي مجتمع يسعى للاستقرار.
- المبادرات المجتمعية
المنظمات المدنية، المبادرات الشبابية، الحملات التوعوية… كلها أدوات لإعادة تشكيل الوعي الجمعي.
الكرد، والعرب، والسريان، والآشوريون، والأرمن…
كلهم مكوّنات أصيلة في نسيج سوريا.
لكن عقوداً من الإقصاء والاستبداد جعلت من التنوع عبئاً بدل أن يكون ثروة.
اليوم، وبعد كل ما مرّ به السوريون من مآسٍ وانقسامات، يبدو واضحاً أن مستقبل البلاد لن يُكتب إلا بثقافة تقبّل الآخر.
ثقافة تحترم الاختلاف القومي، وتقدّر الحقوق السياسية، وتؤمن بالتعايش لا بالكراهية، وتبني دولة تُعطي لكل مكوّن حقه دون منّة.
في الواقع الكردي، لطالما كان الكرد مثالاً في احترام التعددية داخل مجتمعهم، ولكن ذلك لا يعفي أحداً من مسؤولية تطوير هذه الثقافة ليكون التنوّع مصدر قوة، لا مصدر صراع.
إنهم يقولون إن الجهل يولّد الخوف، والخوف يولّد الكراهية، والكراهية تقتل المجتمعات قبل أن تقتل الأفراد.
وتقبّل الآخر هو العلاج الأول لهذا المرض.
إنه دعوة لبناء إنسان يفهم ذاته قبل أن يحاكم غيره،
إنسان يرى العالم من نوافذ متعددة،
إنسان يؤمن بأن الاحترام ليس خياراً، بل شرطاً للوجود.
إذا أردنا أن نبني مستقبلاً حقيقياً، فإن البداية لن تكون من السلاح، ولا من السياسة، ولا من الاقتصاد…
بل من العقل.
من ثقافةٍ تعيد للإنسان قيمته، وللمجتمع توازنه، وللوطن روحه.